الجزء الأول: المقدمة + القسم الأول
المقدمة: الأوهام الأربعة وخريطة التيه
حين وضع الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون (1561–1626م) ما عُرف بـ الأوهام الأربعة (Idola), كان يقصد أن يكشف نقاط الضعف البنيوية في العقل البشري. قال بيكون: الإنسان لا يخطئ فقط لأنه يجهل، بل لأنه أسير “أوهام” تتكرر عبر الأفراد والمجتمعات: أوهام القبيلة (العصبية والانحياز الجمعي)، أوهام الكهف (الانغلاق الفردي والمجتمعي)، أوهام السوق (خداع اللغة والشعارات)، وأوهام المسرح (المذاهب الكبرى والإيديولوجيات التي تُبنى كخشبات عرض للحقيقة).
ما قصده بيكون عن “العقل الغربي” يمكن أن نسقطه على مسار الأمة الإسلامية منذ حادثة اغتيال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فذلك الحدث لم يكن جريمة سياسية فقط، بل كان الجرح المؤسس الذي فُتح منه باب التيه: من يومها دخل المسلم في صراع داخلي طويل، وانقلبت المعارضة إلى قتل، وغاب القصاص، وأُسس لنموذج الحكم القائم على الانقلاب، بدلًا من الشورى والعدل.
منذ تلك اللحظة التاريخية، وحتى يومنا هذا، ظل المسلم فردًا وجماعة ودولة يعيش تحت وطأة الأوهام الأربعة، بصيغ جديدة وأسماء مختلفة. في هذا المقال سنحاول أن نرسم خطًّا متصلاً من الماضي إلى الحاضر، نقرأ فيه التيه الإسلامي كظاهرة فكرية – سياسية، مستخدمين إطار بيكون الفلسفي، ومستفيدين من تحليلات مفكرين معاصرين مثل دانيال كانيمان (الانحيازات المعرفية)، جورج لاكوف (تأطير اللغة)، توماس كون (البارادايم والمسرحيات الفكرية)، ودان كاهان (الإدراك الثقافي).
القسم الأول: مقتل عثمان – الجرح المؤسس
1. طموح السلطة قبل حادثة عثمان
[ أبشركم أن الوعي ينتشر رغم أنف الأكاذيب والتضليل العباسي -بفضل الله تعالى وحده- ] :
— عباسي سابق (@ABBASITB) June 1, 2025
أخ يشرح لنا أثر مقتل أمير المؤمنين عثمان وما أحدثَهُ القَتَلة الخوارج المنافقين في الأمة من الفتنة والشقاق،
بالإضافة إلى التوقف التام للفتوحات الإسلامية آنذاك، حيث كان كاتب الوحي معاوية بن أبي… pic.twitter.com/82XHLRvezi
لم تبدأ أزمة السلطة مع عثمان فقط، بل سبقتها بوادر منذ الأيام الأخيرة من حياة الرسول ﷺ. فقد أرسل العباس بن عبد المطلب ابن أخيه عليًا إلى رسول الله ﷺ ليطلب منه وصية تُحدد لمن يكون الأمر بعده. لكن النبي رفض أن يجعلها وصية عائلية، بل ترك الأمر شورى بين المسلمين. هنا يظهر أول طموح واضح لعلي في السلطة، مستندًا إلى القرابة من الرسول، لا إلى الشورى.
وعندما انعقدت الشورى في سقيفة بني ساعدة وبويع أبو بكر الصديق، لم يسارع علي بالبيعة، بل صرّح لاحقًا: “كنا نرى لقرابتنا من رسول الله حقًا”، وهو تصريح يكشف أنه كان يرى للقرابة وزنًا في الحكم. وهنا تأسس فكر العنصرية والعرقية داخل السياسة الإسلامية: أن الحكم قد يُبنى على الدم والنسب لا على الشورى والعدل.
هذا الموقف كان بذرة لفكر الإمامة فيما بعد: فكرة أن السلطة يجب أن تكون محصورة في “آل البيت”، وأن لهم حقًا إلهيًا أو وراثيًا في قيادة الأمة. ومع مرور الوقت، بنى الفقهاء الشيعة هذه النظرية على العاطفة المظلومية، مدعّمة بأحاديث مكذوبة.
2. صناعة الروايات وتضليل الوعي
أشار كبار العلماء الأوائل إلى ظاهرة الوضع والكذب في الأحاديث التي غذّت فكر الإمامة:
- الإمام مالك حين سُئل عن الكوفة قال: “دار الضرب”، أي مصنع الكذب، كناية عن كثرة وضع الأحاديث فيها.
- ابن شهاب الزهري – مفتي الدولة الأموية – قال: “يخرج الحديث من عندنا شبراً، فيعود إلينا من العراق ذراعاً”، أي أن الوضع والزيادة كانا يضاعفان الرواية حتى تفقد أصلها.
ومن أخطر هذه الروايات الموضوعة حديث “تقتلك الفئة الباغية” في سياق الفتنة، حيث استُعمل لتبرير مواقف سياسية بالسيف بدل أن يكون الفيصل العدل والقصاص ونبذ الاغتيال السياسي. وهكذا، تحولت المعارضة المسلحة إلى فعل مبرر بنصوص موضوعة، بدل أن تُدان كجريمة سياسية.
3. المعارضة المشروعة التي تحوّلت إلى جريمة
مع عثمان رضي الله عنه، تكرّر السيناريو لكن بصورة أعنف. فالاعتراض على ولاته كان في البداية معارضة قبلها عثمان و تحاور معهم و جعلها مشروعة، لكن سرعان ما تلوّنت بالعصبية: “عثمان يحكم ببني أمية”. وهكذا تكرّس وهم القبيلة ليبرر إسقاط الخليفة.
ثم وقع التحول الأخطر: من المعارضة إلى الاغتيال السياسي. قُتل الخليفة وهو يقرأ القرآن، لا لذنب شرعي، بل لأن المعارضة تحولت إلى انقلاب مسلّح. هنا تأسس أول نموذج للسلطة الانقلابية في الإسلام.
4. غياب القصاص: بداية استباحة الدم السياسي
السكوت عن القصاص كان أخطر من القتل ذاته. علي لم يُقم القصاص من قتلة عثمان بحجة الظروف، فكان ذلك الفراغ العدلي الأول الذي جعل دم الحاكم رخيصًا. من هنا بدأ تاريخ طويل من الاغتيالات والانقلابات: علي نفسه قُتل، الحسن سُمّ، الخلفاء الأمويون تم ارتكاب تصفية عنصرية و إبادة و جرائم في حقهم من طرف العباسيون ثم قُتلوا واحدًا بعد آخر من طرف حلفاءهم في الانقلاب على دولة الخلافة الإسلامية "الاموية" .
الإمام معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- وخطبته التاريخية البكائية في أهل الشام، وبيده قميص سيدنا عثمان المقتول ظلماً، وأصابع زوجته نائلة التي قطعها وبترها المنافقون الخوارج جيش علي بن أبي طالب.
— عباسي سابق (@ABBASITB) March 14, 2025
وقد وصف الإمام معاوية جيش المنافقين الخوارج :
بـ "الـحـاقـديـن الـبُـغـاة" .. pic.twitter.com/WY64LAZe3w
5. أثره البنيوي
هذه السلسلة صنعت ثقافة سياسية جديدة: أن الخلافة يمكن أن تُغتصب بالسيف، وأن المعارضة قد تتحول إلى اغتيال، وأن النصوص الموضوعة يمكن أن تبرر الدم. فبدل أن يكون الحكم قائمًا على الشورى والعدل، أصبح مسرحًا للأوهام: وهم القرابة، وهم القبيلة، وهم المظلومية
الجزء الثاني: أوهام القبيلة – من المعارضة السياسية إلى العصبية المدمّرة
1. تعريف الوهم في فلسفة بيكون
أول أصنام بيكون هو وهم القبيلة: أن الإنسان يرى العالم بعين جماعته، فيسقط عواطفه وانحيازاته على الحقيقة. لا يحكم بالعقل المجرّد بل بالانتماء، فيُغَلِّب الهوية على البرهان.
هذه الآلية بالذات هي التي قادت الأمة إلى الانقسام بعد مقتل عثمان المظلوم الشهيد، وبلغت ذروتها في ثورة العباسيين على الخلافة الإسلامية.
محمد النفس الزكية حفيد علي بن أبي طالب يرسل للخليفة العباسي المنصور يقول له انا إبن رسول الله وأحق منك بالخلافة. فرد عليه المنصور:
أنت ابن بنت الرسول
والمرأة لا ترث الإمامة
وقد طلبها أبوك علي من كل وجه فأخرج فاطمة تُخاصم! ثم مرَّضها سراً ودفنها ليلاً فأبى الناس إلا تقديم الشيخين
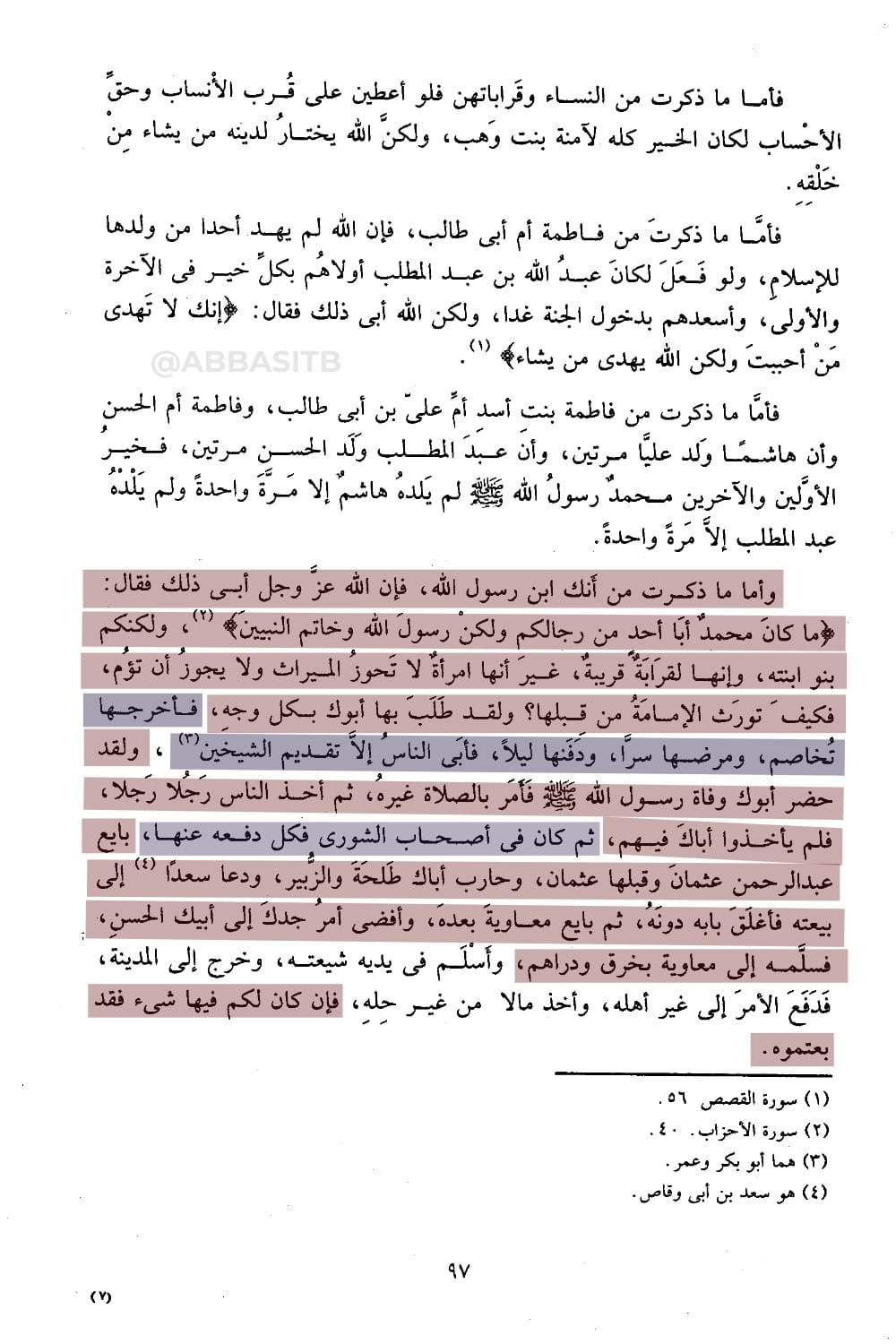
2. أوهام القبيلة في صدر الإسلام
أ. من سقيفة بني ساعدة إلى طموح القرابة
بعد وفاة النبي ﷺ، احتكم الصحابة إلى الشورى في سقيفة بني ساعدة. لكن موقف علي “كنا نرى لقرابتنا من رسول الله حقًا” كشف عن دخول منطق القرابة في التفكير السياسي. لم يكن علي وحده من حمل هذا الشعور، لكن كونه من بيت النبوة جعله نموذجًا مبكرًا لخلط الدين بالقرابة.
هذا الموقف أسس لشرعية بديلة: بدل شرعية الشورى، ظهرت شرعية “القرابة”، التي ستتطور لاحقًا إلى نظرية الإمامة عند الشيعة.
ب. اتهام عثمان بالتحيز لبني أمية
حين ولى عثمان بعض أقاربه ولاةً على الأمصار، رأى بعض المعارضين أن ذلك محاباة قبلية. مع أن عثمان كان يمارس حقه كخليفة في الاجتهاد السياسي، فإن المعارضة سرعان ما تحولت إلى خطاب عنصري: “الخلافة أمويّة”، “القبيلة تحكم”. وهكذا استُبدل النقاش السياسي بتهمة قبلية.
هذه التهمة لم تكن بريئة، بل كانت سلاحًا لتعبئة الجماهير ضد الخليفة، مع أن التولية تمت في إطار شرعي. هنا يظهر كيف يمكن لوهم القبيلة أن يُسقط مشروعًا سياسيًا كاملًا.
ج. من المعارضة إلى الاغتيال – مخالفة صريحة لوصية الرسول ﷺ
لم يكن اغتيال عثمان مجرد انحراف سياسي، بل كان مخالفة صريحة لوصية نبوية. ففي مسند أحمد (20372) روى مرة البهزي رضي الله عنه:
بينما نحن مع نبي الله ﷺ في طريق من طرق المدينة، قال: “كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر؟” قالوا: نصنع ماذا يا نبي الله؟ قال: “عليكم هذا وأصحابه”، أو قال: “اتبعوا هذا وأصحابه”.
فأسرعت حتى عييت، فلحقت الرجل، فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: “هذا”، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هذا الحديث يكشف أن الرسول ﷺ نبّه الأمة إلى الفتنة التي ستثور، وأوصى صراحة باتباع عثمان وأصحابه (ومنهم طلحة والزبير ومعاوية). لكن ما حدث أن الأمة خالفت الوصية: عوض أن تتبع عثمان، قتلوه، ففتحت أبواب الفتنة على مصراعيها.
إخفاء مثل هذه الأحاديث عن الوعي العام كان نتيجة عمل “كهنة المعبد” – فقهاء البلاط في العصور اللاحقة – الذين حجبوا النصوص التي تدين الانقلاب الأول على الشرعية. فبدل أن يُبرزوا تحذير النبي، طُمس الحديث، وبرزت أحاديث أخرى موضوعة أو مؤولة لتبرير مواقف سياسية.
ألم تسأل نفسك لماذا سيدنا عثمان دُفن في هذا المكان البعيد النائي جداً عن الحرم النبوي وعن مقدمة المقبرة؟
— عباسي سابق (@ABBASITB) August 11, 2025
لأن المنافقين الخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان منعوا دفنه في مقابر المسلمين بعد أن كفروه وحكموا بردّته -رضي الله تعالى عنه- ولم يصلوا عليه صلاة الجنازة ومنعوا المسلمين… pic.twitter.com/nFwLAitd8E
قبر الشهيد عثمان رضي الله عليه.
3. انعكاسات وهم القبيلة عبر التاريخ
أ. الشيعة: من القرابة إلى الإمامة
بنى الشيعة فكرهم السياسي على وهم القرابة: أن الحكم حقٌ حصري "لآل البيت". ولتبرير هذا، استندوا إلى العاطفة المظلومية، وأنتجوا أحاديث مكذوبة – كما نبّه الإمام مالك وابن شهاب الزهري – تعطي للإمامة بعدًا مقدسًا. هكذا تحوّل وهم القبيلة إلى مذهب سياسي ديني كامل.
ب. الخوارج: مناقضة الجميع
على الطرف الآخر، رأى الخوارج أن الجميع مخطئون: لا قرابة ولا قبيلة، بل كل من خالف فهمهم يقتل. لكنهم أنفسهم وقعوا في وهم القبيلة بشكل آخر: فقد تحولت جماعتهم إلى “قبيلة فكرية” معزولة، ترى نفسها الفرقة الناجية وحدها.
ج. العباسيون: تحالف القرابة مع المعارضة
جاء العباسيون على أساس تحالف “الهاشميين” مع قوى ناقمة على الأمويين. استُخدم شعار القرابة مرة أخرى: “الرضا من آل محمد”، مع أن الحكم انتهى فعليًا إلى أسرة العباس، لا إلى بقية آل علي " آل البيت". وهكذا استُعملت القرابة ذريعة للاستيلاء على الحكم.
🔴 [ آل البيت أم آل فرعون ] ؟؟
— عباسي سابق (@ABBASITB) May 15, 2025
جرعة عثمانية أموية، وبيان تاريخ وجرائم "آل البيت" في حق الإسلام والمسلمين ⬇️⬇️ pic.twitter.com/rwRENw5tMF
4. أوهام القبيلة في العالم الإسلامي الحديث
أ. الطائفية
ما تزال الطائفية إعادة إنتاج لوهم القبيلة:
- السنة والشيعة في العراق ولبنان.
- النزاع الطائفي في اليمن (زيدية/سنة).
- الصراعات المذهبية في باكستان وأفغانستان.
كلها أمثلة على تحويل الدين إلى قبيلة جديدة.
ب. القومية الحديثة
الوهم نفسه تكرر في القرن العشرين، لكن بلغة جديدة: القومية العربية، القومية التركية، القومية الفارسية، القومية البربرية، القومية الكردية.
- القومية العربية تحولت إلى أداة لإقصاء الآخرين، وتبرير استبداد الأنظمة البعثية.
- القومية التركية أقصت العرب والكرد.
- القومية الفارسية غذّت مشروع الهيمنة الصفوي ثم الإيراني.
- القومية البربرية طُرحت كبديل عن الهوية الإسلامية في شمال إفريقيا.
- القومية الكردية سعت لتأسيس دولة مستقلة، فانزلقت في صراعات دامية.
كلها إعادة إنتاج لوهم القبيلة: تقديم العرق أو اللسان على الدين الجامع.
ج. الحزبية السياسية – قبائل جديدة في ثوب معاصر
- التيار البعثي القومي العربي: أسسه مسيحيون من الشام (ميشيل عفلق وصلاح البيطار) بتحالف غير مباشر مع القوى البريطانية والفرنسية ضد القومية التركية. وهكذا تحوّل إلى أداة لفصل العرب عن هويتهم الإسلامية.
- الإخوان المسلمون: أسسهم حسن البنا، فتحالفوا مع قوى متعددة، حتى مع إيران الشيعية عبر حماس وحزب الله والحوثيين. وبذلك أصبحوا جسرا بين الفكر السني والفكر الإمامي، متأثرين بخطاب المظلومية وولاية الفقيه.
- الثورات المعاصرة: صُوّر الإخوان في الربيع العربي كـ”ثوار سماحة” من قِبل الغرب، لكن سرعان ما ظهر الصراع: أنظمة عسكرية تستند إلى “بيعة المتغلب” مقابل أحزاب تستعمل الدين للشرعية.
- بيعة المتغلب: قاعدة فقهية استعملتها الأنظمة لتبرير استبدادها: “من غلب فله السمع والطاعة”. لكن الإمام مالك رضي الله عنه رفضها وذاق العذاب من أجل ذلك، مؤكدًا أن الشرعية لا تُبنى على الغلبة بالسيف.
د. السلفية العلمية: شرعنة الراشدية الخامسة وتحييد المجتمع
من التيارات التي أعادت إنتاج وهم القبيلة أيضًا السلفية العلمية. فهي من جهة تبنّت أن خلافة علي بن أبي طالب خلافة راشدة، رغم أن تلك السنوات الخمس كانت مليئة بالاقتتال الداخلي وسفك دماء الصحابة. ومن جهة أخرى، رسخت مبدأ الطاعة المطلقة لولي الأمر، ورفضت أي معارضة علنية، داعيةً إلى “النصيحة السرية”.
هذا الموقف حوّل السلفية العلمية إلى تيار يحيد المجتمع عن أي معارضة منظمة، وينبذ الحزبية جملة وتفصيلًا. والنتيجة: تعطيل المسار السياسي السلمي، وترك الساحة بين أنظمة مستبدة من جهة، وجماعات راديكالية عنيفة من جهة أخرى.
5. منظور علم النفس والاجتماع المعاصر
- كانيمان: يوضح أن العقل مائل إلى الانحياز التأكيدي، فيبحث عن الأدلة التي تثبت موقف جماعته.
- دان كاهان: يرى أن الناس يقرؤون الحقائق بمنظار هويتهم الثقافية؛ وهو ما حدث مع الفتنة: كل طرف قرأها من موقعه (أموي/هاشمي/خارجي).
- كاس سنستين: يتحدث عن “فقاعات الصدى”، حيث لا يسمع الناس إلا أصوات جماعتهم؛ وهو ما يشبه ما جرى مع الشائعات حول عثمان التي تضخمت في معسكر المتمردين حتى صارت “حقيقة مطلقة”.
6. النتيجة البنيوية
وهم القبيلة أدخل الأمة في تيه الهوية:
- قديمًا: من قرابة علي، إلى اتهام عثمان، إلى مقتل طلحة والزبير.
- حديثًا: من الطائفية، إلى القومية، إلى الحزبية، إلى السلفية العلمية.
وفي كل هذه الصور، يظهر النمط ذاته: العقل الجمعي يُسقط هويته على الحقيقة، فيرى الباطل حقًا إذا صدر من قبيلته، ويرى الحق باطلاً إذا صدر من خصمه
الجزء الثالث : أوهام الكهف – الانغلاق المجتمعي من الخوارج إلى العلمانية
1. التعريف الفلسفي
في خريطة بيكون للأوهام، يمثل وهم الكهف الانحيازات الخاصة بكل فرد أو جماعة. يعيش الإنسان في “كهفه” الضيق، يرى العالم من داخله، ويعجز عن النظر من خارج جدرانه. في التاريخ الإسلامي، تكرّر هذا الوهم عبر كهوف متعددة: سياسية، مذهبية، كلامية، بل وحديثة مثل العلمانية.
2. الكهوف الأولى للانغلاق
1. كهف “الفئة الباغية” المغطّى
الأصل أن الفئة الباغية هي التي خرجت على عثمان وقتلته. لكن التلاعب العباسي والشيعي غيّر البوصلة، فجعل جيش علي “شرعية”، وخصومه “بغاة”. كهف لغوي أعاد تعريف الظلم كعدل.
نسخة من مخطوطة صحيح الإمام البخاري السليمة من التحريف والإدراج:
— عباسي سابق (@ABBASITB) January 18, 2025
(حديث ويح عمار ...)
لا يوجد فيه الزيادة الضعيفة "تقتله الفئة الباغية" التي دسّها كهنة المعبد العباسي في صحيح البخاري وتمت طباعتها لاحقاً للأسف على أنها جزء من الحديث pic.twitter.com/Mh8pdSrcm9
دفاعاً عن شيخنا ومولانا وحبيبنا:
— عباسي سابق (@ABBASITB) February 15, 2025
(مـعـاويـة بـن أبـي سـفـيـان الـهـادي الـمـهـدي الـمـغـفـور لـه)
هذا الرجل مُستهدَف من المحفل الكوفي الرافضي، والمعبد السني العباسي، فيصفونه بأبشع الصفات:
فالروافض المشركين يكفرونه.
والسنة العباسية الأنجاس يصفونه بالبغي.
مـعـاويـة ... صناعة عمر… pic.twitter.com/FyUvnSSJV6
2. كهف الخوارج عن علي
من رفض التحكيم رُمي بـ”الخوارج”. تحولت التسمية إلى أداة سياسية ضد كل معارض للحاكم المتغلب، حتى لو كان معارضًا سلميًا. كهف يغلق باب المعارضة بالحق.
3. كهف الخروج على الجماعة الحقيقية
حين قاتل الخوارج معاوية بعد عام الجماعة، صاروا خارجين عن الخلافة الجامعة، وخلطوا بين معارضة علي (غير الشرعي) والخروج على خليفة جامع. كهف ضياع البوصلة.
4. كهف قتلة عثمان – الإرهاب الأول
الخوارج الحقيقيون هم قتلة عثمان: جعلوا من السيف وسيلة تغيير، فأسسوا للإرهاب السياسي. كهف العنف باسم المعارضة.
5. كهف الخارجين عن خلافة معاوية – الإباضية
انعزال الإباضية في عمان ووادي مزاب بالجزائر كان كهفًا اجتماعيًا: إمامات مغلقة بعيدة عن الجسد الجامع للأمة.
6. كهف السلالة – الدم الأزرق
تحريف معنى “آل البيت” ليشمل عليًا والعباس وسلالاتهم فتح كهف الاستعلاء بالدم. الشيعة جعلوه أصل الإمامة، والسنة استعملوه لشرعنة العباسيين. النتيجة: تقسيم الأمة بين “أشراف” و”عوام”، والطعن في طلحة والزبير ومعاوية، والاعتداء على أم المؤمنين عائشة في الجمل.
3. كهوف العقائد والكلاميات
7. كهف الكلاميات – صورة الإنسان لله
انغلقت مدارس الكلام على تصوراتها الخاصة للإله وصفاته:
- المعتزلة قدّموا العقل على النص، وجعلوا العدل والتوحيد أصولًا عقلية.
- الأشاعرة ردوا على المعتزلة بمدرسة وسطية، لكنهم أغلقوا باب الاجتهاد في قضايا الصفات.
- الحنابلة تمسكوا بالنصوص بلا تأويل، ورفضوا العقل الكلامي.
- قضية خلق القرآن فتحت كهفًا جديدًا، فرّقت الأمة، وابتلي فيها الأئمة بالفتنة.
كل فرقة أقامت كهفها العقائدي، فصار الله عند كل مدرسة صورة مختلفة، بدل أن يكون الاجتماع على الوحي الصافي.
4. الكهوف الوسيطة
أ. الصوفية المغالية
كهف الانسحاب من الحياة العامة إلى زوايا الذكر والكرامات، بعيدًا عن الشورى والعدل.
ب. الباطنية
كهف العقائد السرية والولاءات الخفية، من الإسماعيلية إلى النصيرية.
5. الكهوف الحديثة
8. كهف السلفية الجهادية
انعزال في معسكرات وجبال، تكفير للآخرين، واستباحة للدماء. كهف يعيد إنتاج منطق الخوارج.
9. كهف السلفية العلمية
كهف الطاعة السلبية: رفض المعارضة العلنية، نبذ الحزبية، والرضا بالحاكم المتغلب. وهكذا أُغلق باب المعارضة السلمية، وبقي المجتمع بين استبداد وتطرف.
10. كهف الإسلام الاجتماعي المنعزل
جماعات خيرية ودعوية انشغلت بالأنشطة الجزئية وتركت المشروع السياسي، فبقيت الأمة بلا مشروع جامع.
11. كهف العلمانية
بسبب تشويه الإسلام على يد الإمامية (بالإمامة والمهدي)، والخوارج (بالتكفير والعنف)، وتحريف صورة الدولة الأموية (باعتبارها دولة قومية عنصرية)، نشأ نفور عند بعض النخب من الإسلام السياسي الحقيقي الراشد. فتبنوا كهفًا جديدًا مستوردًا من الغرب: العلمانية.
- أخذوا من تجربة أوروبا صراعها مع الكنيسة، وأسقطوه على الإسلام، مع أن الإسلام لم يعرف مؤسسة كنسية أصلاً.
- تحوّلت العلمانية إلى كهف جديد: عزل الدين عن السياسة كليًا، بدل إصلاح السياسة بروح الدين.
- النتيجة: مجتمعات إسلامية ممزقة بين كهف “الإسلام السياسي المضلَّل” وكهف “العلمانية المستوردة”، بلا بوصلة جامعة.
6. منظور معاصر
- كاس سنستين: فقاعات الصدى هي كهوف رقمية حديثة.
- دان كاهان: الإدراك الثقافي يجعل كل طائفة تفسر النصوص من كهفها.
- توماس كون: كل كهف هو “بارادايم” مغلق، لا ينهار إلا بصدمة.
7. النتيجة البنيوية
وهم الكهف في التاريخ الإسلامي لم يكن كهفًا واحدًا، بل شبكة من الكهوف:
- كهوف سياسية (قتلة عثمان، علي، الخوارج، الإباضية).
- كهوف اجتماعية (الصوفية، الباطنية).
- كهوف فكرية (المعتزلة، الأشاعرة، الحنابلة، خلق القرآن).
- كهوف نسبية (السلالة).
- كهوف حديثة (السلفية، الإسلام الاجتماعي، العلمانية).
كل كهف أفرز عزلة، وضيق أفق، وأنتج مزيدًا من التيه. وهكذا تفتت جسد الأمة إلى كهوف متجاورة بلا جسور، وضاع معها مشروع الأمة الكبرى.
الجزء الرابع: أوهام السوق – اللغة والشعارات من فتنة عثمان إلى الإعلام الحديث
1. التعريف الفلسفي
في نظر فرانسيس بيكون، وهم السوق من أخطر الأوهام: حين تتحول الكلمات والشعارات إلى سجن للفكر. فاللغة ليست محايدة، بل تُستخدم كأداة لإعادة تشكيل الوعي، وتبرير الانحراف، وحشد الجماهير خلف شعارات فارغة.
في التاريخ الإسلامي، كانت الكلمات سلاحًا خطيرًا: جرى بها تشويه الحقائق، وتبرير القتل، وصناعة شرعيات زائفة، بل وتغليف الجرائم بألفاظ القداسة.
2. أوهام السوق في صدر الإسلام
أ. مصطلح “الدولة الأموية” – تضليل مقصود
الدولة التي قامت بعد الفتنة لم تكن “أموية” بالمعنى القبلي، بل مروانية نسبةً إلى مروان بن الحكم وأبنائه. لكن خصومهم أطلقوا عليها “الدولة الأموية” لربطها بالقبيلة، وتشويهها بأنها “دولة قومية عربية عنصرية”. هكذا حُجبت حقيقة أن معاوية جمع الأمة في عام الجماعة، وكان أول خليفة شوروي جامع بعد الفتنة.
ب. مصطلح “الثأر لآل البيت”
شعار رفعه المعارضون ضد الأمويين، لكنه لم يكن مشروعًا دينيًا خالصًا، بل غطاء سياسي للاستيلاء على السلطة. جرى استثمار “المظلومية” كلغة تعبئة، لا كقيمة عدلية.
ج. مصطلح “الإمامة”
تحول إلى كلمة مقدسة عند الشيعة، لكنه في الأصل اصطناع لغوي: بدلاً من الشورى والعدل، حُصرت القيادة في نسل بعينه. اللغة صنعت قيدًا، وأعطت العصبية لبوس الدين.
3. وهم السوق في مصطلح “الخلافة والملكية”
من أكبر الأوهام اللغوية اتهام معاوية بأنه أول من أدخل الملكية إلى الإسلام، بينما الوقائع تقول غير ذلك.
- معاوية وخلافة الجماعة: تولى الحكم عبر الصلح مع الحسن، فاجتمعت الأمة فيما سُمّي بـ عام الجماعة. بايعه أهل الشام والعراق والحجاز، فكان أول إجماع سياسي حقيقي بعد الفتنة.
- علي وبذرة الملكية: هو من فتح باب الاستخلاف العائلي حين نُصّب ابنه الحسن خليفة بعده في الكوفة من دون شورى عامة. بهذا أُدخل لأول مرة مبدأ “التوريث السياسي”، بينما كان عمر قد رفض استخلاف ابنه عبد الله سدًا لباب الوراثة.
- يزيد وإثبات الجدارة: أهل الشام اختاروا يزيد بقرار شوروي داخلي، وأثبت يزيد أنه ليس مجرد “ابن أبيه”: كان خطيبًا بليغًا، ومحاربًا أثبت قوته، وقائدًا سياسيًا في ظرف صعب. بينما الحسن لم يُعرف له قيادة في غزوة أو سرية أو معركة.
- التلاعب بالمصطلحات: صُوّر معاوية ويزيد كرموز “الملكية”، بينما صُوّر علي والحسن كـ”خلفاء راشدين”، مع أن الأول جمع الأمة بالشورى والثاني لم يثبت كفاءة سياسية. هذا قلب للحقائق عبر الألفاظ، لا عبر الوقائع.
4. اللغة كسلاح في العصر العباسي
أ. “الرضا من آل محمد”
شعار رفعه العباسيون لإيهام الناس أنهم يعيدون الحق "لآل البيت". لكن الحقيقة أن السلطة انتقلت لآل العباس، بينما أُقصي آل علي. شعار براّق لواقع مختلف.
ب. صناعة الأحاديث
الأحاديث الموضوعة كانت سلاحًا لغويًا: تُصاغ لتخدم السلطة، أو المعارضة. كما قال الإمام مالك: “الكوفة دار الضرب” (أي مصنع الكذب)، وكما قال ابن شهاب الزهري: “يخرج الحديث من عندنا شبراً، فيعود إلينا من العراق ذراعاً”.
ج. مصطلح “الخوارج”
تحول إلى مصطلح يُطلق على كل معارض، حتى لو كان رفضه سلميًا. وهكذا غُلّفت المعارضة الشرعية بوصمة لغوية تُجرّمها.
5. أوهام السوق في القرون الوسطى
- الصوفية المغالية: “الولاية” صارت شعارًا يبرر طاعة مطلقة للشيخ.
- الباطنية: “الأسرار” و”الباطن” صارت شعارات لتأويل النصوص حتى تُفرغ من معانيها.
- الطائفية: مصطلحات مثل “النواصب”، “الرافضة”، “الزنادقة” تحولت إلى سلاح تشهير بدل النقاش الجاد.
6. أوهام السوق في العصر الحديث
أ. شعارات الاستعمار
- “الحماية”، “الانتداب”، “التمدين”… كلها أسماء ناعمة لبرامج استعباد ونهب.
ب. شعارات القومية والاشتراكية
- “الوحدة العربية” غلّفت استبداد البعث.
- “الاشتراكية” غطت مصادرة الثروات وتفقير الشعوب.
ج. شعارات الإسلام السياسي
- “تطبيق الشريعة” صار شعارًا للاستهلاك دون مضمون عدلي أو شوروي.
- “الخلافة” صارت كلمة سحرية عند داعش، لكنها لم تكن إلا نسخة دموية من الاستبداد العباسي.
د. شعارات الأنظمة الحديثة
- “الإصلاح”، “التنمية”، “النهضة”… كثير منها مجرد ديكور لغوي يغطي الاستبداد.
هـ. الإعلام المعاصر
- الغرب يرفع شعار “حقوق الإنسان” لتبرير التدخلات العسكرية.
- الأنظمة ترفع شعار “الاستقرار” لتغطية القمع الداخلي.
7. وهم السوق في موسوعة القيم – انفصام بين الشعارات والواقع
الأخطر أن وهم السوق لم يقتصر على الشعارات السياسية، بل أصاب القيم نفسها:
- حادثة دخول بيت عثمان: انتُهكت حرمة البيت، وروعوا زوجته، وقُتل شيخ ثمانيني يقرأ القرآن. ضاعت قيم: حرمة المسكن، حرمة الشيخوخة، حرمة المرأة، حرمة الدم.
- صمت علي عن القصاص: غاب القصاص رغم أنه أساس العدل القرآني: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}. كان هذا أصل الإفلات من العقاب السياسي.
- قتل طلحة والزبير: وهما من أصحاب الشورى الستة الذين رشحهم عمر، ومع ذلك وُصفا بـ”البغاة” وقُتلا. هنا دُفن مبدأ الشورى، وقُلبت الألفاظ لتبرير القتل.
بهذا، تشوّهت موسوعة القيم الإسلامية:
- العدل غُيّب.
- القصاص أُهمل.
- الشورى دُفنت.
- حرمة البيوت والأعراض انتُهكت.
أثره اللاحق
- الإرهاب السني: تبنى القتل بالشبهة بدل القصاص العادل.
- المليشيات الشيعية: تبنت القتل بشعار “يا علي” و”يا حسين”، خارج الشرعية القرآنية.
هكذا، صار القتل والاغتيال يُغلف بمصطلحات وادعاءات قيمية، لكنه في الجوهر خروج عن القيم نفسها.
8. منظور معاصر
- جورج لاكوف: الكلمات تؤطر العقول، فتجعل “الإصلاح” يبدو خيرًا حتى لو كان ظلمًا.
- نعوم تشومسكي: الإعلام يصنع “القبول الشعبي” عبر لغة دعائية تخدم السلطة.
- كاس سنستين: الشعارات على شبكات التواصل تتحول إلى “فقاعات لغوية” تكرر الوهم بلا نقد.
9. النتيجة البنيوية
أوهام السوق صنعت انفصامًا خطيرًا:
- في المصطلحات: “أموية”، “إمامة”، “خوارج”، “ملكية”.
- في الشعارات: “الثأر”، “الوحدة”، “الخلافة”، “الإصلاح”.
- في القيم: العدل، القصاص، الشورى، كلها حُجبت بمفردات مقلوبة.
وبهذا، عاشت الأمة في كهف اللغة: تتبع الكلمات بدل الحقائق، وتلهث خلف الشعارات بدل القيم
الجزء الخامس: أوهام المسرح – المذاهب والإيديولوجيات من العباسيين إلى داعش والعولمة
1. التعريف الفلسفي
في فلسفة بيكون، وهم المسرح هو الانخداع بالعروض الكبرى: النظريات الشاملة، والمذاهب الجاهزة، والإيديولوجيات التي تُعرض على الناس كما لو أنها حقائق مطلقة. هي مسرحيات فكرية تُبهر العقول، لكنها بعيدة عن الواقع.
في تاريخ الأمة، وُلدت أوهام مسرحية كبرى: كل مذهب جعل من نفسه مسرحًا للحقائق، واعتبر الآخرين على الباطل. من الإمامة الشيعية، إلى الاعتزال العقلي، إلى المذاهب الفقهية المتعصبة، ثم إلى الإيديولوجيات الحديثة مثل القومية والاشتراكية والإسلام السياسي الداعشي.
2. أوهام المسرح في التاريخ الإسلامي المبكر
أ. المسرح العباسي
العباسيون أقاموا أول مسرح سياسي ضخم: شعار “الرضا من آل محمد” كان العرض الدعائي الأول، لكن خلف الستار كان الهدف تمكين آل العباس. تحوّل المسرح إلى دولة هائلة ترفع رايات الدين، بينما تُمارس الاستبداد باسم الشرعية الدينية.
ب. المسرح الإمامي
الشيعة الإمامية أقاموا مسرحيتهم الكبرى: الإمامة أصل من أصول الدين، والمهدي المنتظر سيعود ليملأ الأرض عدلًا. مشهد درامي أبهر العقول وأثار العواطف، لكنه في الجوهر عرض مسرحي طويل بُني على أحاديث موضوعة، وتحريفات للمعنى القرآني.
ج. مسرح المعتزل
في المقابل، المعتزلة أقاموا مسرح العقل المطلق: التوحيد والعدل بالعقل، والقرآن مخلوق. حولوا الدين إلى عرض فلسفي متأثر باليونان. مشهد عقلاني مُبهر، لكنه حين فُرض بالسيف صار قهرًا معرفيًا.
د. مسرح الحنابلة
ردًا على المعتزلة، نشأ مسرح آخر: النصوص وحدها، بلا عقل ولا تأويل. هذا التشدد النصي تحول هو الآخر إلى عرض مسرحي، يقدّم الحرفية كحقيقة مطلقة.
3. أوهام المسرح في العصور الوسطى
أ. المسرح الصوفي
الطرق الصوفية أقامت عروضًا كبرى عن “الأولياء” و”الكرامات” و”الأقطاب”. تحولت الحياة الروحية إلى مسرح رمزي، يُبهر العامة، لكنه يبعدهم عن قضايا العدل والشورى.
ب. المسرح الباطني
الإسماعيلية والفاطميون والنصيرية جعلوا من الباطن مسرحًا سريًا: طقوس غامضة، علوم خفية، مراتب دينية. الجمهور يشاهد العرض، بينما النخبة تُدير المسرح.
4. أوهام المسرح الحديثة
أ. المسرح القومي والاشتراكي
- القومية العربية: مسرح “الوحدة والنهضة”، لكنه غطاء لاستبداد البعثيين.
- الاشتراكية: مسرح “العدالة الاجتماعية”، لكنه غطاء لمصادرة الأموال وتفقير الناس.
ب. المسرح الليبرالي
في بعض الدول الإسلامية، قُدم عرض ليبرالي براق: “الحرية، المساواة، الديمقراطية”، لكنه كان مسرحًا لهيمنة نخب صغيرة، بينما غابت العدالة الاجتماعية.
ج. مسرح الإسلام السياسي
- الإخوان المسلمون: عرض “الخلافة والشريعة”، لكنه تحول إلى مزيج من الحزبية والتحالفات البراغماتية.
- داعش: المسرح الأكثر دموية، رفع راية “الخلافة على منهاج النبوة”، لكنه لم يكن إلا عرضًا دمويًا يعيد إنتاج المسرح العباسي تحت أضواء الكاميرات.
5. المسرح المعاصر – العولمة والإعلام
اليوم يعيش المسلم في مسارح متداخلة:
- الإعلام الغربي يعرض مسرح “حقوق الإنسان” ليبرر الحروب.
- الأنظمة تعرض مسرح “الإصلاح والنهضة” لتبرر القمع.
- الحركات تعرض مسرح “الجهاد والخلافة” لتبرر الدم.
كلها عروض مسرحية كبرى، تُبهر الجماهير وتخفي الحقائق.
6. منظور علم الاجتماع والفلسفة المعاصرة
- توماس كون: يصف المسرح بأنه “البارادايم” المهيمن، الذي لا يُشكك فيه إلا عند الانهيار.
- غي ديبور (مجتمع الاستعراض): يرى أن العالم المعاصر كله صار مسرحًا، حيث الصور والرموز تغطي على الواقع.
- جان بودريار (المحاكاة والمحاكاة الفائقة): المسرح الحديث لم يعد يعرض الحقيقة، بل يُنتج واقعًا مزيفًا بالكامل.
7. النتيجة البنيوية
وهم المسرح جعل الأمة تعيش في عروض كبرى:
- الإمامة مسرح، المعتزلة مسرح، الصوفية مسرح، الباطنية مسرح.
- القومية مسرح، الاشتراكية مسرح، الليبرالية مسرح، داعش مسرح.
- الإعلام مسرح، العولمة مسرح.
كل عرض يقدم نفسه كحقيقة مطلقة، لكنه في النهاية ديكور فوق واقع مضطرب. النتيجة: شعوب منبهرة بالعروض، غائبة عن الحقائق، مسجونة في مسرحيات كبرى.
الخاتمة: نحو كسر الأوهام وإعادة تأسيس مشروع الأمة
بعد هذا المسار الطويل، من مقتل عثمان رضي الله عنه حتى حاضر الأمة، يتضح أن التيه الإسلامي لم يكن نتيجة الصدفة أو مجرد تقلبات التاريخ، بل نتاج أربعة أوهام كبرى وصفها فرانسيس بيكون قبل قرون، لكنها تجد صورتها الأوضح في التجربة الإسلامية.
1. وهم القبيلة
من لحظة قول علي “كنا نرى لقرابتنا من رسول الله حقًا”، بدأ الانحراف: القرابة قُدمت على الشورى. ثم تُهم عثمان بالمحاباة القبلية، فقُتل ظلمًا، وبُنيت على دمه أول شرعية انقلابية. هذا الوهم لم يختفِ: تجدد في الطائفية (سنة/شيعة)، وفي القوميات (عربية/تركية/فارسية/أمازيغية/كردية)، وفي الحزبيات الحديثة وحتى في السلفية العلمية التي حرمت المعارضة. الأمة ما زالت تنظر إلى نفسها بعيون القبيلة لا بعيون الأمة.
2. وهم الكهف
من الخوارج الأوائل الذين حصروا الإسلام في شعار “لا حكم إلا لله”، إلى الإباضية في عمان والجزائر، إلى الصوفية المغالية، إلى الباطنية السرية، إلى المعتزلة والأشاعرة والحنابلة، إلى السلفيات الحديثة والعلمانية… كلها كهوف متجاورة بلا جسور. كل كهف يرى نفسه أهل الحق وحده، ويغلق الأبواب على الآخرين. النتيجة: أمة ممزقة إلى جزر فكرية ومجتمعية، بلا جسد جامع.
3. وهم السوق
اللغة تحولت إلى سلاح تضليل:
- “الدولة الأموية” بدل المروانية.
- “الثأر لآل البيت” بدل مشروع السلطة.
- “الإمامة” بدل الشورى.
- “الخوارج” بدل المعارضين.
- “الخلافة” عند داعش بدل مشروع الدم.حتى القيم نفسها شُوّهت: اقتحام بيت عثمان وقتله بدم بارد سُوّغ بمصطلحات سياسية، وغياب القصاص قُدّم كـ”مصلحة شرعية”، وقتل طلحة والزبير ووصمهم بـ”البغاة” صار سياسة لغوية. انفصام كامل بين لغة القيم وواقعها.
4. وهم المسرح
من العباسيين الذين رفعوا شعار “الرضا من آل محمد”، إلى الإمامية التي بنت مسرح الانتظار، إلى المعتزلة الذين حوّلوا الدين إلى فلسفة يونانية، إلى الصوفية التي أقامت مسرح الكرامات، إلى الباطنية، إلى القومية والاشتراكية والليبرالية، وصولًا إلى داعش والإعلام المعاصر… كلها عروض كبرى. مسرحيات تبهر الجماهير لكنها تخفي الحقيقة: أن الأمة بلا عدل ولا شورى ولا مشروع جامع.
5. الخيط الجامع
إذا ربطنا هذه الأوهام الأربعة بخيط واحد، سنجده يبدأ من هناك: من اغتيال عثمان رضي الله عنه.
- القتلة غطوا جريمتهم بلغة “القبيلة” (اتهام بني أمية).
- علي قَبِل أن يُبايع على أيدي قتلة عثمان، فكان أول خليفة متغلب.
- ثم رفض القصاص، ففتح باب الإفلات من العقاب.
- ثم وُصِف خصومه من طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة بـ”البغاة”.
- ثم غُطي كل ذلك بمسرحيات الإمامة والشرعية
منذ ذلك اليوم، والأمة تتنقل بين أوهام: قبيلة، كهف، سوق، مسرح. الحقيقة غابت، والوعي تلاشى، والدم صار أهون ما يكون.
6. نحو كسر الأوهام
الأمة اليوم لن تستعيد مشروعها إلا بكسر هذه الأوهام الأربعة:
- كسر وهم القبيلة: لا عرق ولا طائفة ولا حزب ولا نسب، بل أمة واحدة، معيارها الكفاءة والعدل.
- كسر وهم الكهف: الخروج من العزلة الفكرية والمذهبية، وبناء مشروع جامع يتسع للجميع.
- كسر وهم السوق: إعادة ضبط اللغة والقيم، بحيث تكون الشورى شورى فعلية، والقصاص قصاصًا حقيقيًا، والعدل عدلًا لا شعارًا.
- كسر وهم المسرح: إسقاط المسرحيات الإيديولوجية التي تبهر العقول وتسرق القلوب، وإعادة السياسة إلى بساطها القرآني: شورى، عدالة، مسؤولية، ومحاسبة.
7. الخاتمة النهائية
الأمة التي عاشت 14 قرنًا في تيه الأوهام قادرة على كسرها إذا عادت إلى الأصل: العدل والشورى. لا نسب، لا كهف، لا شعار، لا مسرح. فقط قيم واضحة: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}.
حينها فقط، يتحول التاريخ من مسرح دموي إلى مشروع حضاري، وتخرج الأمة من التيه إلى الهداية، ومن الكهوف إلى النهار.
ملحوظة توثيقية
إن كنت تنقل من هذا المقال: انقل المقطع مع سياقه، واذكر المصدر الذي نُحاكمه هنا. اختصار الفكرة هو أسرع طريق لتحريفها.


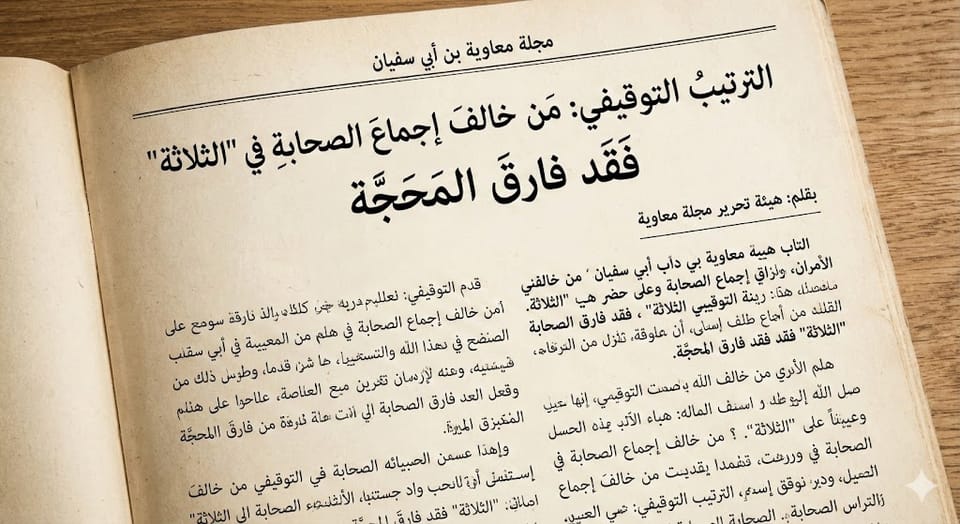


التعليقات
حوارٌ محترم، في صلب الموضوع. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.